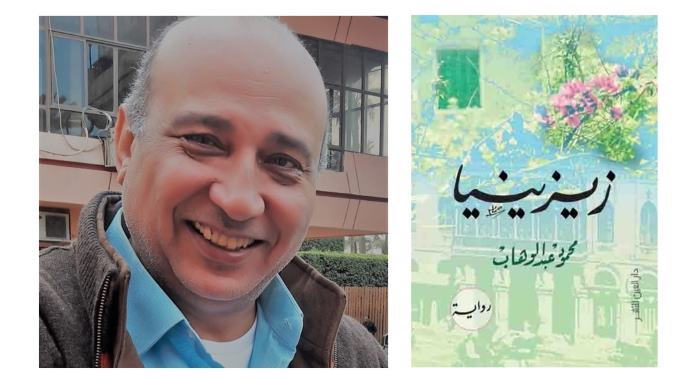الخال
كانت حرب أكتوبر1973 قد انتهت بالكاد عندما جاء محمد إلى زيزينا ليقيم عند أخته فترة عمله بالاسكندرية.
صعد الجزء الأول من السلم الخشبى الطويل ثم كانت هناك بسطة صغيرة أمامها شباك زجاجى عملاق مقسم بالخشب إلى مربعات بألوان مختلفة، إجتازها ثم بدأ يصعد الجزء الثانى من السلم والمؤدى إلى طرقة البيت، تلك التى كانت المكسوة أرضيتها بسجادة حمراء طويلة مرسوم عليها مربعات سوداء كبيرة بداخلها نقشت الورود.
كنت واقفا فى الطرقة أنتظره وهو رآنى بمجرد وصوله إلى البسطة فبادرنى مبتسما:
- إزيك يا كيكى
كان خالى رجلا ممشوق القوام، طويلا، وسيما، وقد تراجع شعر رأسه من الجانبين لكن هذا التراجع لم يصب مقدمة الرأس. عندما صعد قبلنى ثم دخل فورا إلى غرفته ذات الشباكين الكبيرين، والتى يطل أحدهما على الحديقة الخلفية للفيلا، بينما يطل الثانى على القصر الكبير ذى الحديقة مترامية الأطراف وأشجار الكافور التى تتناثر فى الأرجاء. هناك بدل ملابسه استعدادا لتناول الغداء ثم جلسنا سويا إلى منضدة السفرة وبدأ يحكى بعضا مما يمكن قوله عن القضية التى جاء يترافع من أجلها.
بعد يومين بالضبط وقع محمد فى ورطته الصحية الأخيرة. نقلوه إلى المستشفى، وهناك عرفوا الحقيقة. كان مصابا بسرطان فى المعدة. واستمرت رحلته مع المرض ستة أشهر لا غير لم يغادر فيها زيزينيا إلا إلى المستشفى حيث كان المرض متمكنا من جسده الرشيق، إلى أن غادر الحياة فى 27 إبريل 1974
عادت المدارس للانتظام بعد توقف حوالى شهر ونصف أثناء حرب أكتوبر1973، وبدأت وأنا فى الصف الأول الاعدادى أذهب فى الصباح المتأخر إليه فى مستشفى المبرة، أسلم عليه وأضع وجبة الغداء التى كانت تعدها أمى فى الصباح، على المنضدة القريبة، ثم أجلس بجانبه إلى ان يحين موعد المدرسة فى الفترة المسائية.
أتذكر كلماتهم فى تلك الفترة عن عملية محتمله سيجريها له الدكتور دويدار المشرف على حالته، لكن يظل الشىء الأكيد أن محمد رجع إلى فيلا زيزنيا فى النهاية ومكث فيها حوالى أربعة أشهر إضافية إلى أن مات. كانت الحالة متأخرة ولذلك أوصى الدكتور بنقله إلى البيت لتقليل التكلفة، ولأنه لا يوجد شىء يمكن للمستشفى أن يقدمه.
عاش محمد هذه الفترة على حقن الأفيون لتخفيف الألم. وكان أبى يذهب مساء إلى زيزنيا يوما بعد يوم يعطيه الحقنة. كنت أيامها فى الثانية عشر من عمرى، وكانت ثقتى فى أبى بلا حدود، ولذلك كنت متأكدا فى أنه سيجد حلا فى النهاية ينتصر به على المرض، كان عزائى دائما فى اجتماع أبى مع زوج خالتى لعلاج محمد والنظر فى أمره، أما أمى فكانت حزينة على الدوام، ونما هذا الحزن داخل نفسى على الرغم من مقاومتى له بالتمسك بالأمل فى قدرة أبى التى لا حدود لها.
وكنت أزوره كل أسبوع. كانت الحجرة بها سريران متجاوران من الحديد. وكان ينام دائما على السرير البعيد عن باب الغرفة والقريب من الشباك المطل على القصر. وجاءت فترة بدأت الهمهمات تتصاعد فى أسرتى عن قرب النهاية. كان قد بدأ يدخل فى نوبات غيبوبة كثيرة وزهد فى الأكل إلى أبعد حد. وذات يوم جمعة زرته فى حجرته. كانت الشمس تملأ الغرفة، وأمامه على السرير صينية بها بعض الطعام وكوب بيرة. كنت أعلم أن الدكتور قد أوصى له بالبيرة كفاتح للشهية. حدثنى كثيرا فى ذلك اليوم، إلى أن فاجأنى بقوله:
- عارف يا حماده أنا لما أخف أول حاجة حأعملها إيه؟
- إيه؟
- ح أبطل بيرة وحأصلى. وبعدين لما نرجع مصر حأوديك الأهرامات وحأفسحك فى كل حتة.
كان الكلام كله جديدا على، فلم يسبق لخالى أن فسحنى أو امتلك وقتا لذلك، كان حانيا نعم، ومرشدا لى فى أشياء كثيرة، أما موضوع الفسحة فكان أمرا غريبا أن يذكره، خاصة أننى كنت أعلم بقرب النهاية، وتساءلت فى تلك اللحظة وأنا أنظر إلى عينيه عما إذا كان يعلم أم لا يعلم. أذكر أنى سمعت نفس تلك التساؤلات من أمى كانت توجهها لأبى.
اضطررت إلى الاستئذان بدخول الحمام وتركت خالى لفترة ثم عدت إليه. كانت إبر محاليل الجلوكوز قد تركت أثرها على ساعديه فأخذت أنظر إليهما وشعورى بالدهشة من طريقة كلامه لى لا تفارقنى.
فى صباح اليوم التالى جاءت إجابة كل شىء. كنت نائما فى حجرتى عندما دق جرس الباب، قام أبى ليفتح بينما أمى كانت فى الحمام استعدادا للعمل. سمعت صوت أنكل على وهو يتحدث مع أبى وأحسست بانقباض مخيف وأخذت أصرف ذهنى عن التفكير.
خرجت أمى من الحمام وماهى إلا ثوان ودوى صوتها ببكاء عنيف متصل. صوت كأنه عويل ونحيب فى الوقت نفسه. ولم أكن بحاجة إلى سؤال أحد عما يجرى.
جرت الأيام بسرعة وهم سافروا فى اليوم نفسه للقاهرة للدفن فى مقابر الأسرة، وحضرت عمتى للبقاء معنا فى البيت والاشراف على شئوننا حيث كانت امتحانات نهاية العام على الأبواب.
سأذهب بعد الانتهاء من الامتحان إلى القاهرة وسأقيم فى بيت جدتى وسأعرف شكل الشوريك والخمسان والأربعين وسأكره كل تلك المظاهر إلى الأبد.
وبعد وفاة محمد بستة أعوام فقط سأعيش فى نفس الغرفة التى أقام فيها آخر شهور عمره، وسأقيم فى فيلا زيزنيا لمدة ستة أعوام أخرى. وسأظل أذكر نفسى دائما بأنها نفس الغرفة.
الغريب ما قالته أمى لى مؤخرا، من أن خالتى فايزة كانت موجودة لتشهد وفاة محمد، لم تكن أمى تتحدث عن محمد بل عن فايزة، فقالت إنها المضحية الكبيرة، والتى تقف مع أخواتها وقت الشدة، لأنها ستكون موجودة أيضا عند وفاة فاطمة بعد ذلك بسبعة عشر عاما. عندما تشعر فايزة بقرب أجل أحدهم، تترك الدنيا بسهولة بالغة وتقيم بجانب ذلك الذى يستعد للرحيل.
كانت فايزة وقتها على وشك الزواج، ولتسهيل حضور خطيبها وإقامته معهم فى المنزل تم عقد القران فى صالون الفيلا، ليستطيع أن يبيت معهم عندما يحضر من القاهرة، بلا حرج.
كنت مندهشا عند سماع حديث أمى، كيف لم اشعر بأن فايزة كانت هناك وقت الوفاة؟ وكيف لم أحس بأنفاسهم التى كانت قد بردت عندما أقمت فى الفيلا بعد ذلك؟ كيف لم تخبرنى حوائط البيت؟
ثم بعد ما يقارب الأربعين عاما، وبعد وفاة فايزة فى القاهرة. أقلب فى أوراقها، فتقع عيناى على رسائلى إليها وأنا فى الثالثة عشرة، وتفع أيضا على شىء آخر: على عقد زواجها، مكتوب فيه العنوان الذى تم فيه العقد، زيزينيا، والشهود، الذين كان أحدهم أنكل على.