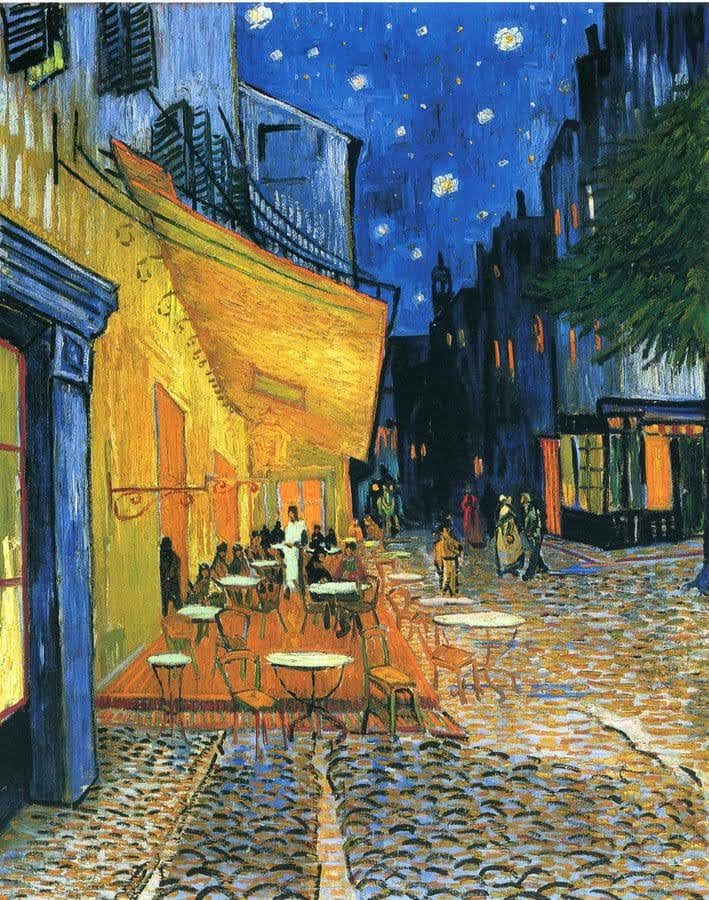قالت لها العرافات:
”ستخرجين من عتمّتك إلى إشراقٍ، يملؤك بالنّور. فلا ترين سوى درباً أخضر، وجُدُر تسلقتها نباتات الخرّيف، وبين بين.. نّهرين من اللبنِ والخمر، على ضفافيهما تنهض أشجار المانجو، التي تغرّد بين تلافيفها، طيور الجنّة الملونة، وتجلس تحتها الطواويس والغزلان.. ستخرجين من عتمّتك إلى بوحٍ ندي، فيخاطبك النّاس بالشعرِ، وتردين عليهم بلُغَّةِ العصافير المقيمة والطيور المهاجرّة، وطيور ”الرّهو!“ و.. وتدركين أول الأنبياء.. تحكى له عن طّي الزّمن، والمسافات.. والوجوه المغبرّة، وعكرّة خلفتها وراءك. فيبادلك الحكمة، ويبتسم ثم يسجد.. تنتظرينه وتنتظرينه، لكنه لا يرفع عن السجود. فتغادرين إلى الإشراقِ..“..
خرجت خدّيجة من الغرفةِ المعتمّة، دون أن تُعير ولد العرّافة الصغير، المتكئ على مواربةِ الباب، أدنى التفاتة!
مضت في الدّربِ المتعرّج، تتجنب المستنقعات والبرّك الصغيرة، في الزقاقِ المظلم، وهي تتلفت.. تخشى أن تهاجمها كلاب الحي على حين غرّة!
وهى تخلع ثيابها حائلة اللّون، لترتدي قميص نومها الدّاكن.. الخشن، سألتها أمها بلامبالاة:
”أين تأخرت كل هذا الوقت؟!“
فأجابت باقتضابٍ وهي تستلقي على سريرها:
”أخذّتنى مرّيم إلى جدّتها العرّافة“
كانت صديقتها الوحيدة مريم، قد ألحت عليها، بالذّهاب معها إلى جدّتها ذات المهارّات المتعدّدة. قالت:
”فهي تخط الودع.. تقرأ الكف.. تضرب الرّمل وتفتح الكتاب!“
.. بعد أن تضع أعواد البخور على المباخرِ العديدّة، المنتشرّة في الغُرفةِ الضيقة. الصغّيرة، بضؤها الكابي، الموّحي.. فيتصاعد الدّخان السحرّي، محيلاً الرؤية إلى ضبابيةٍ، متقشعة. يسرِّب الخدّر، والإحساس بالوجعِ اللذّيذ.. الخفي، في كل شيء.. حتى قطع الأثاث العتيقة..
كانت مرّيم دّهِشة للسؤالِ الذّي يطرحه حال خدّيجة، فهجست بالإجابة عنه، بإحضارها إلى جدّتها (ولية الله الصالحة بنت يونس)، التي –يُقال– وُلدت مختونة، وعزفت عن طلبِ الرّجال، إلى أن تقدم بها العمر. وصارّت من القواعدِ..
لكنما، ماء شبابها كأنه لم يغيض.. إذ لا تزال نضرّة، لم يغشاها غضن! ولم يخط عليها شيب!
وعندما حدّثت مرّيم جدّتها بالحَكَّاية. تبسمت الجدّة عن أسنانها الناصعة المكتمّلة، ولم تنبث ببنت شفة!
في البدءِ رفضت خدّيجة الذّهاب، ثم لانت. كأن قوّة خفّية نهضت فجأةً، لتدفعها دفعاً.. وعندما خرجت من غرّفة الجدّة، كانت مرّيم قد اختفت من الصالةِ، حيث تركتها، قبل أن تدخل على الجدّةِ، التي مضت بها في دروب ذلك العالم البرزّخى، تدفعها دفعاً لقطعِ وهادّه وسباسبهِ، إلى أن توقفت عند شجرّةِ (السِّدر) في المنتهى.. فترّكت خدّيجة تسير وحدها! كطيفٍ سابح في بحرٍ من النّورِ الكُّلِّى!
لم تبحث خدّيجة عن مرّيمٍ، وغادرّت بيت الجدّة في عجلة، وهي تتعثر في قطعِ الأثاث بطريقها، دون أن تشعر بها. إلى أن لفحها تيار هواء بارد، فأدرّكت أنها بمنتصفِ الزّقاق، المفضي إلى الشارعِ الرّئيسي.
كانت خديجة منذ طفولتها تبدو كغزّالةٍ نافرّة، فعندما تبدأ الفتيات في لعبةِ (الحجلة أو عريس وعروسة) تقصِّى نفسها كـ (وزينة) على ضفافِ بحيرّة شاسعة. تخشى التوّغل.. تتركهن يمرّحن وحدّهن. وتراقبهن وهي تنشد: ”الزّارعينا في كبدِ البوصة..
نّــي نّــي.. مــــًــو نجيض (,,)
الطّــير كــلى البر ســوسة..
الـزارعينا في كـبد الغــابة..
نّـــي نّـــي.. مـــو نجيض (,,)
الـــطير كـــلى الـــورتابة“
وظلت هذه الأُنشودّة، تعزّية وحدتها. منذ ذلك الوقت. وكانت حين ترغب في فصلِ نفسها عن العالمِ حولها، تتراجع متسحبة إلى داخلها، وتدخل في حالةٍ لا شعورّية، وتبدأ في ترديد أُنشودتها المحببة، بصوتٍ عميق، ملؤه الأسى واللَّوعة.
كأن طقساً بكاملهِ، تؤديه جُوقة من الرّهبان.. إلى أن يخترق صّوت مرّيم الرّخيم عالمها الطقسي:
”النّـــاس عـــرّسوا..
أنا في النمّيم يا يابا..“
هكذا تشرّخ مرّيم عالمها في كل مرّة، فلا تملك سوّى أن تنظّر إليها بمحبةٍ، وهي تمسح حبات العرّق من وجهِها، وتبتسم دون تعليق!
سنوات غرّبتها تمضي بخُطىً وئيدّة، كتسحبِ الشّمس شيئاً فشيئاً، قبل أن تغيب. وطفل مرّيم الذي أرسلت لها صورته –في السنة الأولى لولادته– يكبر. يصير صبياً، وسيماً، تطل شقاوّة أمه من عينيهِ.
تبتسم خدّيجة عند هذا الخاطر، وتُدّخل أخر الصّور، –التي أرسلتها إليها مرّيم قبل شهر.. للصّبي الذي صّار شاباً أليف الملامح، صّبوح الوجه– في إطارٍ مذهب حذاء التسرّيحة!
في غرّبتها المترّفة تنفتح حياتها على بوحٍ قدّيم، ظنت إنها خلفته وراءها.. بوح يطل برأسه من رّحم الماضي، بين آونةٍ وأخرى.. يخز رّغباتها الغامضة: التي ليست لديها فكرة واضحة عنها، فقط محض رّغبات في التلظي والتشظي.. تخرج منها إلى صلواتٍ سرّية طويلة، تختمّها بتلكِ الأُنشودّة التي تحبها، دون أن يخترق صّوت مرّيم عالمها الطقوسّي ويشرّخه!
تتفجر كوامن شجنها لوجهٍ غامض، تعرّفه ولا تعرّفه. يجيء بملامحهِ المبهمّة، من خلفِ ضباب المغيب، لحظة ما قبل الفجر الغامضة.. يصبح كيانها كله مشدوداً كوترِ كمان، عميق الجُرحِ والآهة.. أسيان كندى فجر شاحب!
يخرج إبن مرّيم من الصّورة.. يعزف حتى تكل يداه من العزف المنفرد، فيتوقف عن العزفِ، وتخرّج مرّيم من سطورِ الخطاب.. تشُد الوتر –وجدان خديجة– وتعزف نغماً مألوفاً، عن الشجنِ والترّقب، فتهتف فيها بكل تحفز: (إنه هو!).. فتتوقف عن العزفِ.. تستند على ساقِ النخل، كالمنهارّة. تدّخل فيه.. تتلاشى!
وعبثاً يطول انتظارها لخروجِ مرّيم.. فمرّيم كانت قد احتضنت إبنها، وغابت في سطورِ الخطاب!
تعيد خدّيجة الصّورة إلى التسريحة.. تلوكها الهواجس والظنون، فتحترق بنيرانِ الأسئلة، إلى أن يأخذها النّوم، وتمضى بها الأحلام إلى عالمٍ مضئ..
تتلفت حولها لترى مصدّر الضوء، وعبثاً تبحث.. فإضاءته من اللا مكان: لا شرق. لا غرب، لا شمال أو جنوب!
تتسلق حائطاً أخضر. يبدو لها ناعماً. وتسبح بعده في نّهر الخمر. تتشرّب مسامها بالخدّر. وتتسع رؤاها ورؤيتها، فتدرك الضفة الأخرى منهكة، و.. وهى بين الصّحو والنّوم، تحط على كتفِها يمّامة، وتقترّب غزّالة، لتجلس إليها في حنوٍ. تحكّي لها عن الذّي وجدته مُلقىً على شاطئ البحر وحيداً، ينضح بالعذّاب. فسقته من ثدّيها: (كان ينضح بالعذابِ!).. تؤكد، فتبتسم اليمّامة: (العذّاب غسول الصالحين).. وتحلق، تحلق..
لتجد خديجة نفسها بين منزلتين..
لطالما حلمت في تلك النّهارات البعيدّة، بوجهه غجري الملامح. يأخذها من قلبِ حلقة (الذِّكر)، ويمضى بها في مسارّاتٍ نّهارية غائظة بالتوجسِ، مشحونة بالمغامرّة، بين احتمال موت جدير بحياتيهما، وحيَّاة لا تدّركها تلك الهواجس والظُّنون، التي عانتها في انتظاره المضني الطويل!
كطاقةِ بعث –كانت حياتها– تخرج من قلب دهاليز التارّيخ وأزقته وحواريه، في مدنه المدفونة..
طاقة تتفجر هكذا، كبركانٍ. تجتاح حممه كل شئ. لتدفعها دفعاً لارتياد عوالمٍ لا تدركها. فقط تحسها. وتكاد تتلمسها. بأحاسيسها التي ترى ما لا يُرى!
حاولت أن تغلق قلبها دونه، لكنه ينفتح على شبح وجهه، غامض الملامح!
وجهه المحزون بخذّلان حوارييه. وخيانة الصديق القريب (حتى أنت يا..).. وجهه المندفع من عالمٍ سرّمدي.. بعيد.. بعيد.. لا تدركه الأبصار.. فتهتز خديجة كنخلةٍ، في مهبِ الرّيح.. يحاصرها ”التساب“ في غمرّة الإدراك لوجودها غير المدرك!
وتمضى في رّحابِ عالم تصله ولا تصله. وإذ تصله لا تجده. وهو فيها. وهى فيه. يتماهيان. فلا يصبحان واحداً. بل صفراً. مركزاً للواحد.. وواحداً على هامشِ الصفر!
(تتوّحد) فيه حد التلاشي، ولا يعود لهما وجود: (صفر)..
وخز شفيف وشقّي، يجبرها على طردِ هذا الخاطر.. وخز يتكوّن كدملٍ. يتحفز للانفتاحِ على نافذةٍ مترّبة. بتعاقبِ الفصول!
لثمة خفّية تنزعها من مكانِها. تتلفت حولها. وتستكين. خدر.. بلسم يهدئ صبوتها.. عذابها الجُرح.. فتترقب وجهه أكثر!
وجهه الغامض يلوح في شفقِ المغيب فجأةً، كما صعد فجأةً! تاركاً صالبيه: حيارّى.. مروعين مما شبه لهم، في ذلك الفجر المحتقن بالمخاوفِ والظُّنون، وينذّر بالمخاطر!
يمضى بها.. يعلق أحلامها ويعزف على الكمان، أغنية الانتظار –للجُرحِ العذّاب– لمخلصها من عذّاباتِ الوصول.. (العذّاب.. العذّاب غسول الصالحين..).. يضج أنينها بالشجنِ وتتأوه.. ألم الغرّبة القاحلة واحتراقاتها..
وهذا الموت الذي يدنو حثيثا، ليقودها إلى (الفناءِ)، مبدداً تصّوراتها عن الحيّاةِ والنّاس والأشياء.. ذاك الوجه الغامض، الذي يتبدى عن بوحِ الكمان، في تلافيفِ شجن الوتر!
الشجن العصِّى على البوحِ.. الشجن الذّي يقلق وحدتها.. تتشظى به.. ويمضى أكثر لوعة والتياع!.. يمضى ولا يجئ.. يغيب في سُرمديتهِ.. وتحت وطء الانتظار تغوص، في أرخبيل شائك (أوليس الحب شوك؟).. يدفعها الشوق. تعبره ملأى بالجروح المتقيحة، وتتمدّد تحت نباتِ (اليقطين).. تتشكَّل معه (هُوِّية واحدة): محض نور!
يطل وجه العرّافة المقعدّة.. منتصبة كانت وهي تتقدّم تجاه خدّيجة ببطءٍ.. تعبر إليها من مكانٍ بلا ملامح، حيث تقف في الغيابِ!
تبدّل وجه العرّافة. حل محله وجه إبن مرّيم شاباً فتياً، متلفعاً ببُردة الكتان الناصعة ذاتها.. تقدم منها فاتحاً ذرّاعيه.. لحظتها كانت أحلامهما (هي ومريم) قد غلب عليها الغموض.. لا، متألقة في الغموض!
كان قد اقترب منها.. و.. واستحالا إلى لا شئ. تبددا في الضّوء الذي يغمر أسقف البيوت الواطئة. الشجر، أوكار الطيور، جحور القوارّض، حظائر الحيوانات الأليفة، ووجوه المارّة.. عابري السبيل..
تتلاشى ذكرياتها القدّيمة، لتتشكَّل اللاذكريات. يتلاشى الحنين إلى الحنين. ذكريات الطفولة، شارع البيت، أشجار الحوش الكبير، قهوّة منتصف النهار، الطريق إلى محطةِ المواصلات، وعاصمة بلادها الملبدّة بالحذّر!
عاصمة بلادها المشحونة بالمخاوفِ والهواجس والظنون!
وحنينها لأسرتها، لعالمها ذاك المختزن في خلايا الأماكن وأوردتها وشرايينها!.. النّاس والأشياء..
يتلاشى كل شئ.. يتشكّل فقط وجه الحبيب، في بُردتهِ الكتّان الناصعة. يقترب شيئاً فشيئاً إلى سطحِ عالم الحنين المنهار.. ليحل مركزاً لوجودها وكيانها وحسها.. ويلعبان اللعبة ذاتها: يكر فتفر. تفر فيكر.. و... و.. وثم يدهمها ليلاً ليخطف منامها، ويقطف وردة جُرحها، فيتغذّى الحنين من بوحِ تلك اللحظات الغامضة والحالمة. التي رُبما عاشاها أو لم يعيشاها معاً، أو توهمته وإنما عاشتها خدّيجة وحدها!
فقط تشعر خديجة بمرّيم تتقمصها. وإبنها يحتضنها حتى تئن ضلوعها!.. و.. ويغلبها التمزّق والإرهاق، فتغرّق في نومٍ أسيان!
أحلامهما (هي ومرّيم) غلب عليها الغموض والتوجع، المستمد من أعماقِ غربتيهما، رّكاميهما، البلىٰ الذّي حاصرّهما، وكل التخثّرِ الذّي حاولتا تمزّيق أغشيته، للإفلاتِ من تبدُدِ الزّمان والمكان، والشروع في الحُلمِ!