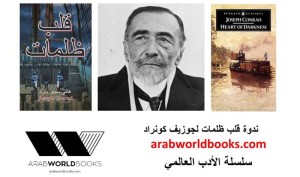خدع فنية، ومتاهات نصِّية حافلة بقوَّة التصوير الشعري والنهايات اللامرتقبة " فوق كفِّ امرأة " لفاطمة ناعوت
بقلم الناقد العراقي : عدنان حسين - أمستردام
عندما حاولت أن أفحص بعض المكوّنات الثقافية التي تشكّل عنصراً مهماً من عناصر التخيّيل الثاوية في ذهن الشاعرة فاطمة ناعوت، لكي أقف على سر المفارقة اللافتة للانتباه في تميّزها عن الشعرية السائدة، وألامس بعض أسباب هذا التشظي الشعري الذي يحطّم دائرة " الائتلاف " ليتمترس بقوة في فضاء " الاختلاف " المُشاكس للذائقة العامة الخاملة التي تتماهى مع التوصيفات والأطر الفنية الجاهزة أو المُستهلكة التي فقدت بريقها جرّاء الاجترار والتكرار، وجدتُ أن الكثير من مرجعياتها، ومصادرها الثقافية التي أسهمت في تشكيل أسَّها المعرفي، وذاكرتها الشعرية، أو المنْجّم الروحي الغامض الذي قد ينفتح في أية لحظة ليباغت الشاعرة نفسها بما ينطوي عليه من محمولات المفاجأة والدهشة، والإتيان بالصور الشعرية التي لم يأتِ بها الشعراء الأسبقون
وجدت أن هذه المكوّنات الجنينية في الأقل لم تخرج عن إطار الثقافة الكلاسيكية التي تحتفي بالشعر الجاهلي، أو برموز القصيدة العمودية التي لم تتزحزح عن البحور الخليلية الستة عشر الميتة التي تضطرب في حمّاها وكأنها تبحث عن شيء ضائع لا أمل في العثور عليه. وعلى رغم انقطاع الشاعرة ناعوت إلى كتابة النص الشعري التقليدي المعلّق بأنشوطتَي الوزن والقافية، والقصيدة الحرة المفعّلة لسنوات طوال، إلا أنها وبفعل مجسّاتها النقدية الرهيفة لم تُعر شأواً لهذه القصائد المتشحة بالأزياء الخليلية الستة عشر وهي تجد طريقها إلى حفل النار أو تتوسد قاع سلة المهملات التي إلتهمت كمّاً هائلاً من الأوزان والقوافي المنتحرة التي تبددت في طيات المجهول.
لقد قرأت ناعوت الشعر الجاهلي، والمعلقات السبع، والمتنبي، والمعري، والبحتري، مثلما أطلت على المنجز الكلاسيكي الأجنبي، فتمثلت نصوص شكسبير، وأوسكار وايلد، وأدغار ألن بو وسواهم من شعراء وناثرين، غير أن بوادر الإنقلاب المعرفي والذوقي قد بدأ يتبلور في ذهنها مع اكتشافاتها التدريجية لعوالم " جماعة المهجر " وشروعها في الاقتراب من النفَس الحداثي لكتّاب قصيدة النثر الأجانب على وجه التحديد، هذا الجنس الأدبي الذي يختلف تماماً عن القصيدة العربية المتعارف عليها بشكليها التقليدي والحر. من هنا ينبغي قراءة هذا النوع الأدبي الجديد بمعايير نقدية مستمدة من هذا النمط الشكلاني المختلف عن الأشكال الشعرية السابقة، من دون محاكمته أو تقويمه أو أخذه بجريرة القصيدة التقليدية التي تتوافر على شروطها النقدية الخاصة، وهذا، مع الأسف الشديد، خطأ قاتل لم ينجُ منه أغلب النقاد العرب الذين تعاطوا مع تجربة قصيدة النثر التي بلغت عقدها السادس في العالم العربي.
على وفق هذا التصور الجديد ينبغي أن نقرأ تجربة فاطمة ناعوت الشعرية التي اتسمت منذ البدء بالنضج، والمغايرة، والوعي المرهف بأدوات النص الشعري الجديد الذي يتميز بقدرته التعبيرية الفائقة، وحساسيته الفنية المستمدة من قوة الجملة السردية المُتقنة التي تخلو من الزوائد والاستطالات التي تشوّه متن القصيدة المرسومة على ملمس البياض الذي يفضح النشوز التشكيلي، ويضيق ذرعاً بالإيقاعات المرتبكة. سأتوقف في هذا المقال عند مجموعتها الشعرية الرابعة التي انضوت تحت عنوان إشكالي مرواغ، كما هو دأبها في كل العناوين التي تنتقيها بعناية خاصة، وهو " فوق كف امرأة " والذي يحيلنا مباشرة إلى واحدة من قصائد الديوان " الإبجرامية " التي تعتمد على تقنية الومضة أو اللحظة التنويرية أو الضربة الخاطفة التي تفضي إلى الكشف والتنوير والدهشة في آن معاً، والتي سأتحدث عندها لاحقاً، إذ تقول " كلما مات رجلٌ / نبتت زهرةٌ / فوق كف امرأة ".
ولكي نلج قصيدة ناعوت من المدخل الصحيح للمتاهة النصية لابد أن نعرف سمات هذا النص " المراوغ " الذي يعتمد على حيل تقنية ومضمونية كثيرة ومعقدة في حقيقة الأمر على رغم البساطة الظاهرية التي تتقنع بها هذه القصائد النثرية. فما هو طبيعة هذا النص الشعري الذي تكتبه ناعوت؟ وما هو كم الشعرية الكامن في تضاعيف هذه القصيدة التي أغوت النقاد، حتى بعض المتزمتين منهم، وجعلتهم يؤازرون دعوتها في الذهاب إلى مناطق عذراء لم يطأها إلا القليل من الشعراء المبدعين، وما تزال غير مأمونة العواقب؟ وما هي البنية الداخلية العميقة التي تمور في داخلها " الخدع الفنية " التي تبهر القارئ وتأخذ بتلابيبه؟ ومن خلال معاينتي لأغلب نصوص ناعوت اكتشفت أنها ترتكز في وضع ثيمتها على رأس الدبوس، وتتأرجح في بنيتها التحتية على ذروته الناتئة، أو أن الفكرة ذاتها، في أي نص من نصوصها، لا ترتضي إلا أن تجازف في السير القلق على حافة حبل السيرك المحفوف بالمخاطر والمفاجآت دائماً. فتقنية " الحافة " هي هدفها، وآلية الاعتماد على " الأنفاس المتقطعة " للقارئ أو السامع، أو انتظار المفاجأة هو ديدنها.
هي بوصفها شاعرة مجنّحة يحلو لها أن تصف هذه المنطقة الشعرية بـ " الفضاء اللامكتمل " أو بحيّز" البين بين " وكلاهما حسّاس، وشديد الخطورة، لأن حجم الشحنة الشعرية التي تملأ فضاء الهرم الناقص الذي سيكتمل بوضع اللمسة النهائية إما أن يقوّضه تماماً أو يستقر به أبد الدهر في الذاكرة الجمعية لمحبي الشعر ومريديه. هذا النمط من الكتابة لا يأتي عفو الخاطر، ولا ينجم عن كتابة آلية " أوتوماتيكية " لأن عقدة النص تحتاج إلى حل يفضي إلى الدهشة أو يقود إلى الصدمة والذهول الناجمين عن الإرتطام بقوة التصوير الشعري، أو الانبهار الشديد بالنهاية اللامرتقبة التي ستعصف بكل التوقعات المرتقبة التي كان ينتظرها القارئ، ويعوّل عليها اعتماداً على حدوسه العقلانية المخيبة للآمال. فالشطحة الشعرية الخلاقة لا تومض ما لم تفلت المخيلة من أُسار الواقع، وتحلّق في تخوم الحلم، ذلك الفضاء الأثير الذي تتشظى فيه مثل لعبة نارية.
لابد من الإقرار بأن فاطمة ناعوت هي شاعرة " ماكرة " بالمعنى الإيجابي، فنصها دائماً يحتمل أكثر من قراءة، ويستوعب أكثر من تأويل، وحتى سيرتها الذاتية المُجسدة شعراً، يمكن قراءتها بوصفها نصوصاً مُستعارة من حيوات الآخرين. وأناها " العليا دائماً " تختلط بأنوات الآخرين، وذاتها هي امتداد للموضوع الكوني الأكبر. بمعنى أنها ليست منشغلة بالسفاسف اليومية، والموضوعات الصغيرة العابرة، لأن ذهنها المتأجج مسكون بالقلق، والشك، واللايقين، وهو يراهن على ما تسميه الشاعرة نفسها بـ" العصف الذهني " الذي يرجّها أولاً، ثم تنتقل هذه الرجّة إلى قارئها أو سامعها فيسقط في برزخ اللذة الإبداعية وهو ذروة ما يبتغيه خالق النص ومنتجه.
ولعلني لا أغالي إذا قلت بأن فاطمة هي من بين الشعراء القلائل الذين وظفوا أغلب الفنون القولية وغير القولية في نصها الشعري، فثمة إيقاعات داخلية غريبة، مموسقة بذاتها، وثمة صور تشكيلية بإمتياز يندر أن تفلت منها قصيدة مهما كانت قصيرة أو مركزة أو مكثّفة، وثمة لقطات سينمائية بزوايا نظر مختلفة، هذا ناهيك عن هيمنة البنية المعمارية التي تشد متن النص الشعري الطويل على وجه التحديد، وهناك النَفس الدرامي الذي يتصاعد من خلال الهاجس السردي الذي لا تُخطئه الأذن المدربة. وربما يكون الشيء الحاسم في قصيدة ناعوت أنها تتسامى على المعاناة اليومية لتتشبث بالهّم الوجودي، هذا القلق المزمن الذي لا يريح ولا يستريح، وتتعاطى معه بطرق وأساليب لغوية لا تخلو من الطرافة، والفكاهة حيناً، والسخرية اللاذعة أو الكوميديا السوداء حيناً آخر.
ثمة قصائد قصار تختصر الألم الروحي والفيزيقي في أقصى لحظات عنفه كما في هذا النص القائم على بنية المعادل الموضوعي " جسدكَ أتلفته النساء / جسدي أتلفه الصدأ " هذه الكلمات الثلاث الأخيرة هي اختصار للعذاب الأنثوي الفيزيقي حين يصرخ الجسد بالرغبة المكبوتة، ويتعالى في أرجائه صهيل النزوات المنفلتة، لأنه يقدّم اقتراحاً مضاداً للتأكسد، ويدعو ضمنياً إلى فرك الصدأ، ولكن بصيغة فنية متعالية تتجاوز من خلالها الاستخدام الصريح للغة الجسد، وما تنطوي عليه من إيحاءات عابرة لا تخلف إلا أثراً مؤقتاً سيزول بعد القراءة الأولى حتماً. وربما لهذا السبب جاءت إشادة بعض النقاد بأن فاطمة ناعوت قد تخلصت من هاجس الكتابة الجسدية الذي هيمن على معظم الشواعر من بنات جيلها أو من الأجيال السابقة، في حين أن القضية تبدو أعمق بكثير من هذا التصور السطحي الذي لا يلامس إلا القشور، ولا يفلح في الإمساك بالعصب النابض للهاجس الجسدي. في قصيدة قصيرة أخرى تعادل ديواناً من الشعر الجميل حينما تقول " هل تعلم أن البحر يتبعنا؟ لا تنظر إلى الخلف.
" يا ترى أية قصة حب عجيبة مُستلة من زمن الأساطير والخرافات تلك التي تحرّض البحر لأن يتخلى عن شواطئه ليتبع خطواتهم الذاهبة صوب اقانيم النشوة؟ الكثير من الشعراء يكتبون قصيدة الومضة، لكن أغلبهم يفشلون في صياغة الجملة الختامية. بينما تقول فاطمة " يقشّرني / ورقة ورقة / فيتعثّر القطار في ظله " أو " لا تستسلم لرغباتي / الطعامُ سيحترق! " ربما تكون القصيدة الأخيرة أنموذجاً لحالة يومية شائعة قد تحدث بسبب البلاهة أو البلادة أو النسيان، ولكن من يخطر بباله أن الطعام سيحترق إذا استسلم " هو " إلى رغباتها الإيروسية المحمومة. هذه النصوص المتقشفة المُستقطرَة إلى هذا الحد يمكن لها أن تصل إلى قوة القول المأثور أو الحكمة البليغة. من خلال هذه الومضات الجمالية يستطيع القارئ أن يتسلل إلى مسارب النص الذي تكتبه فاطمة ناعوت، ويسبر أغواره العميقة، ويفك رموزه المستعصية، وطلاسمه الغريبة، ويلج إلى عوالمه المستغلقة عبر ممرات الدهشة المثيرة لشهية القراءة، والمحرضة على رغبة الاكتشاف والتعرية، فالقارئ غالباً ما يتماهى في روح الشاعر، ويتمرأى فيه، أو يقف على بعد سنتيمتر واحد من أنفاسه في الأقل!