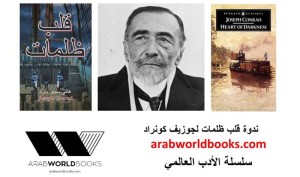الحافة 14/04/2007
حوار محمد قرني
الشاعر إبراهيم داود أحد الأصوات الشعرية المتميزة وسط جيل الثمانينيات في الشعر المصري، هذا إذا سلمنا بصحة هذا المنطق في التحقيب العشري، وقد ميزته ـ وسط أقرانه ـ بساطة الجملة الشعرية وطزاجتها في آن معا، ورغم أنه مشغول بتفاصيله الصغيرة ـ كما يعترف هنا ـ إلا أنه لم يفقد العمق الذي يميز مفردات عالمه عما عداه من عوالم شعرية تكتنف قصيدة النثر الراهنة عبر ذات الآليات، لذلك فهو شديد الحذر من ألا تذهب تفاصيله أدراج الرياح باستهلاكها وتكرارها، وهو ما يؤكد الديوان الجديد الصادر لإبراهيم داود قبل عدة أيام عن دار ميريت للنشر تحت عنوان حالة مشي ، وهو ديوان ـ رغم صغر حجمه ـ يمثل انتقالة أكثر وعياً وتجذيرا في تجربة الشعراء، وتؤكد كذلك علي ملامحه التي طرحتها شعريته في الدواوين الستة التي أصدرها داود وهي علي التوالي تفاصيل، مطر خفيف في الخارج، لا أحد هنا، الشتاء القادم، تفاصيل وتفاصيل أخري ، بالإضافة لمختارات شعرية أصدرتها دار ميريت أيضا، وكتاب نثري بعنوان خارج الكتابة .
وفي هذا الحوار يعترف داود بالكثير من المؤثرات الأولي وعن المحطات التي تمثل منابع تجربته، كذلك تعرج علي الهموم التي تحيط الواقع الثقافي الذي أصر الشاعر علي تناوله باعتباره جزءا من الأوجاع العامة التي تشير الي انغلاق العديد من مسارب الخارطة الشعرية، كذلك انسداد شرايين المؤسسة، حول تلك القضايا وغيرها يتحدث إبراهيم داود، وهنا الحوار:
في البداية أريد أن تحدثني عن مفهومك لقصيدة التفاصيل الصغيرة، وكيف أصبحت تمثل متنا شعريا بالنسبة لك، وما هو معيار الحكم علي هذه التفاصيل؟
التفاصيل في الشعر قائمة طيلة الوقت، أنا فقط أعليت من شأنها، لأنني انتبهت مبكرا الي أن الحياة هي المصدر الرئيسي للمعرفة، وأنني لا أكون صادقا، إلا إذا كتبت عن تفاصيل تخصني، والمشكلة ليست في قصيدة التفاصيل، فهناك عدد كبير من شعراء ما يسمي بجيل التسعينيات يكتبونها، ولكنها غير كافية لصنعة شعر، المعيار دائما مع قصيدة التفاصيل أو غيرها هو الروح التي تجلس خلف القصيدة، ولهذا نجد معظم شعراء التسعينيات توقفوا عن الكتابة واتجهوا ـ في بعض الحالات ـ إلي الرواية، لأنهم بحكم السن أولا، لم يكونوا قد تدربوا روحيا علي كتابة شيء يشير ولا يفصح، وظنوا أن التفاصيل في حد ذاتها، تستطيع أن تفي بالشروط الشعرية، وهذا غير صحيح، وأحب هنا أن أشير الي أنني عندما بدأت في كتابة القصيدة لم يكن في ذهني أنني أكتب قصيدة تفاصيل، ولكنني كنت في حاجة للتخلص من كابوس قصيدة السبعينيات، وكنت أبحث عن آخر لا أعرفه لكي أبوح إليه بشيء، وطوال عمري لم أكن مشغولا بأن آخذ رقما في طابور الشعراء، ولم أكن ايضا أكتب الشعر وما زلت لكي أحرر العالم أو أفجره، لأنني اعتبر الشعر من الممكن أن يجعل العالم أجمل، وعالمي الخاص يشير إلي مواطن يعيش في هذه اللحظة من تاريخ البشرية، ويري الشعر في التفاصيل التي لا يلتفت إليها أحد، رغم أنها هي عالم الجميع، وقد صدر ديواني الأول عام 1988 وكانت قصائده قد بشرت قبل ذلك بأربع سنوات قبل صدوره.
ولذلك عندما ظهر بعد ذلك في بداية التسعينيات ما سمي آنئذ بشعراء هذه الحقبة وذهب أحمد طه وأمجد ريان ليكونا ناظرين لمدرسة، راحا يزعمان أن هذه ثورة جديدة في الشعر العربي.
لم أكن مندهشا، وبعد سنوات كف هؤلاء الشعراء عن الكتابة، لأن ولاءاتهم كانت غير طبيعية، وجاؤوا الي الحياة الثقافية غير مكتملي النمو، فضاعوا.
لقد ظن هؤلاء أن النص الجديد ينفي النص القديم، وهذا غير صحيح لأن الشعر العربي ـ بعكس بقية الفنون ـ يتكون عبر نوع من التراكم وليس عبر القطائع، إنهم بدأوا من النقطة الأخيرة.
وبالنسبة لي فلم أدخل أبدا إلي النص محملا بماهية مسبقة، لكنني بداية من ديواني لا أحد هنا كانت القصيدة تدفعني لاختيار شكلها، أما الديوان الأخير فقد اكتشفت أنني عدت الي منطقة طفولية وأن الحنين الي الماضي يزداد، لذلك يزداد اليوم عبر استخدام تقنيات روائية ومشهدية أقرب الي فنون الصورة، وهو ما ساعدني علي انتاج شكل أوسع، علي الأقل من حيث المضامين والمفاهيم.
حدثني عن مؤثراتك الأولي وروافدها، وكيف تشكلت شعريتك عبر هذا المجري؟
تأثرت في بداياتي بشعر محمود حسن إسماعيل، ويعتبر هو صاحب الفضل الأول في اختياري الطريق الذي سرت فيه، وتأثرت أيضا بالرواد، وأنا لا أحب شعراء بعينهم ولكني أحب قصائد.
وبعيدا عن تأثري توجد أشياء أظن أنني استفدت منها أكثر مثل الغناء المصري وتلاوة القرآن والغناء الشعبي وعوالم الدراويش، لأن هذه الروافد تلعب أساسا علي تيمة البداهة التي لم ينتبه إليها شعراء كثيرون، وأيضا استفدت من السينما والمسرح والرواية والعمارة.
پولكنك متهم بالتأثر بعدد من شعراء قصيدة التفاصيل، وعلي رأس هؤلاء سعدي يوسف ثم يأتي بعد ذلك كفافي وريتسوس؟
لفترات طويلة لا أعرف لماذا تأثرت بشعر سعدي يوسف، ولكن في البداية عليك أن تعرف أن هذه ليست تهمة لأن سعدي شاعر كبير وصديق جميل، ولكني لم أقرأه سوي بعد أن صدر ديواني الأول، فاكتشفت أنه شاعر ذكي وصانع ماهر، ويملك مهارة الحرفي العجوز الذي يجلس إلي قطعة صغيرة ويتفنن في تغيير ملامحها ليكتشف الشعر فيها، وهذا عكس مفهومي تماما، لأنني أري أن دافعي للكتابة شعري بالأساس، وأنا أحب شعر سعدي يوسف مثلما أحب شعر محمود درويش وحجازي، وسعدي ابن هذا الجيل لم يكن متقدما عليهم شعريا ـ في رأيي ـ وأنا اغتاظ منه كثيرا عندما تكون بين يديه قماشة شعرية رائعة لا تحتمل بعدا سياسيا فيختمها دائما بمغزي ما يقلل من قيمتها الشعرية، أما كفافي وريتسوس ومايا كوفسكي وأونجاريتي ورامبو فهؤلاء جميعهم أقرب الأقرب إلي وجداني من كثير من المكتوب في الشعر العربي الحديث، لأنهم يمثلون أرواحا عظيمة قبل أن يكونوا شعراء عظاما، أما أقربهم إليّ فهو كفافي لأنه صاحب قصيدة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الشعر، رغم تناقض منابع كفافي مع تجربتي لأنه عادة ما يلجأ لإحياء عوالم قديمة عبر الإشارة إلي مرادفاتها في الواقع.
التقسيم الجيلي كيف تنظر إليه، وهل أفاد في الفرز علي المستوي الإبداعي؟
فكرة الأجيال موجودة وستظل، وكل جيل له ملامح وعاش تجارب متقاربة، والذين يحاولون تسخيف فكرة الأجيال هم مخترعوها، والآن يخافون من زحف أجيال صاعدة، حتي لا يقال إنهم أصبحوا من حطام الماضي، ففي مصر يوجد جيل الرواد والستينات، والسبعينات والثمانينات والتسعينات حتي لو جاء شاعر ينتمي لجيل سابق واستفاد من حساسية الجيل التالي تظل روحه مختلفة عن هذا الجيل.
وكيف تري الجيل الذي تنتمي إليه؟
جيل الثمانينات هو أهم جيل في الحركة الشعرية المصرية الآن، لأنه أولا متنوع، فقصيدتي مختلفة عن قصيدتك، وقصيدة فتحي عبدالله وعلي منصور مثلا، ومع هذا أحس أنهم أبناء أيامي، وأنهم يواصلون ما بدأوا بدأب بعيدا عن حسابات السبعينات، وغرور الرواد المشغولين بالمجد.
الثمانينيون لم يتورطوا إلا في الشعر والحياة، لذلك هم من أدخل هواء نقيا الي الشعر، ولا بد أن يعلم السابقون أننا في زمن ضد الزعامات.
ألا تعتقد أن الاتكاء علي التفاصيل الصغيرة وحدها يدفع التجربة إلي مناطق تكرار ونضوب مبكر؟
پتفاصيلي الآن هي تفاصيل حياتي، ولم يحدث نضوب كما تقول، أنا فقط أصبحت قليل الانتاج وأصبحت مشغولا أكثر بالعمارة، وأصبحت أكثر حزنا.
في البدايات كنت أملك عينا بريئة وتعاملت مع المدينة بجرأة أحسد عليها، وبعد كل هذه السنوات اكتشفت أنني لم أعد الفردي الذي كنت أخاف منه وأنا صغير، واكتشفت ان الشعر لن يغير العالم، فقط من الممكن أن يجعله جميلا ومحتملا.
كيف تري الهجوم الذي لا يبدو منتهيا علي قصيدة النثر؟!
پأعتقد أن هذا الهجوم، لا سيما هجوم الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي علي قصيدة النثر هو أول انتصار حقيقي لها.
إن التجربة مستمرة ـ رغم كل شيء ـ في التطور والتشكل منذ أكثر من خمسة عشر عاما، ولا أبالغ إذا قلت أنها أهم شيء في حياتنا الآن.
أنت من الشعراء غير المشغولين بالسفر أو الترجمة إلي اللغات الأجنبية تحقيقا لتوسيع رقعة وجودك، لماذا؟
أحب أن أعترف لك بأن عددا كبيرا من المبدعين مشغول بالترجمة، علي أمل أن يهتم بهم الخواجة ويعطف ويربت علي أكتافهم، وأسأل دائما: هل الذين تترجم أعمالهم إلي لغات أجنبية يقرأ لهم أحد في مصر والوطن العربي أولا؟ ودائما لا أجد إجابة.
ومع ذلك فقد ترجم لي عدد لا بأس به من القصائد الي الفرنسية والانكليزية ولم أشعر في لحظة بفرح حقيقي مثل فرحي بنشر قصيدة جديدة، حتي ولو في مطبوعة شديدة الفقر وقليلة الإمكانيات مثل المطبوعات التي يصدرها طلبة الجامعة، لأنني أكتب الشعر بلغة عربية وأبحث من خلاله عن أصدقاء يعرفونني.
وكيف تري الصحافة الثقافية في اللحظة الراهنة؟
لا توجد صحافة ثقافية أو أدبية في مصر، لأنك أمام مجموعة من المصالح وأمام خيال قديم لا يرعي في الثقافة إلا معارك خارج الثقافة، لم نسمع عن قضية ثقافية حقيقية، نحن أمام كراسٍ يحرص الجالسون عليها أن تدوم، وتدوم معها السفريات وبدلات السفر.
وما الذي يزكي هذا الدور في رأيك، وما المقابل؟
المكافآت التي تعطيها المؤسسة الرسمية لا تستحق هذه المذلة، واللافت في الفترة الأخيرة وربما قبل ذلك، تلك الأسماء التي تمثل مصر في كل شيء، انها أسماء إما أقلعت عن الكتابة ودخلت أو أصوات مائعة لا تقول شيئا يهدد السلام الثقافي المستتب في القاعات المكيفة.
وهذا ما يشعرك أن وزارة الثقافة في رحلة ترفيهية تقدم فيها ساندوتشات و نمر وتفرغ وإصدارات بالكوم ليس لها أي معني، وذلك بقصد إفساد الأعمال الجميلة القليلة بالكثير من الأعمال الرديئة.