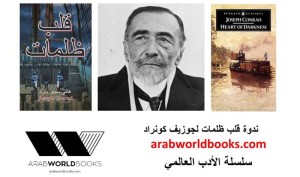تثير هذه الرواية المهمة للكاتبة الصحفية نجوى شعبان جملة من القضايا الفكرية والفنية، منها ما استشهدت به الكاتبة من أقوال الآخرين في افتتاحية الرواية أو بعض فصولها، مثل قول ول ديورانت (صاحب موسوعة قصة الحضارة): "معظم التاريخ ظن وتخمين والبقية الباقية تحامل وهوى"، ويبدو أن الكاتبة على قناعة تامة بمثل هذه المقولة، التي ربما كانت إحدى المحركات الأساسية وراء البحث عن فترة تاريخية مصرية مثيرة في القرن السادس عشر الميلادي، وهي فترة ما بعد دخول العثمانيين مصر، وإعلان مصر ولاية عثمانية عام 1517 م. لقد اختارت الكاتبة تلك الفترة لأنها تتشابه ـ أو ربما تكاد تتطابق ـ مع ما تمر به الأمة العربية الآن، خاصة بعد سقوط بغداد، واحتلال العراق ـ مجددا ـ والتهديدات المماثلة لدول عربية أخرى.
تتساءل الكاتبة في ـ أحد الحوارات التي أجريت معها عقب صدور الرواية ـ لماذا وصلنا كعرب ومسلمين إلى هذا الحد؟ لِمَ نحن هكذا الآن؟ هل هناك عوامل خارجية؟ وتُجيب: بالتأكيد نعم، وتضيف: لكن أية حضارة لا تأفل، أو على الأقل تتعرض لهزات عنيفة تؤدي إلى تراجعها إلا عندما تتآكل جذورها، فقد كان القرن السادس عشر قرنا مفصليا، فرأيت أن تدور رواياتي عنه. أيضا تختار نجوى شعبان عبارة من جاك دريدا يقول فيها: "الوهم أشد رسوخا من الحقيقة، بل إنه متجذر فيها بالدرجة التي يضحى متطابقا معها ومطابقا لها تماما".
ولعل هذا ما جعل الكاتبة تبتعد تماما عن استحضار شخصيات تاريخية معينة عاشت في تلك الفترة التي تتحدث عنها، فلجأت إلى الإيهام الفني الجميل باختيار شخوص روايتها من عامة الشعب، وبالتالي فهي لا تعيد كتابة التاريخ، ولكنها تصنع من التاريخ لحما ودما، عن طريق انحيازها للطبقات الشعبية التي عاشت في مدينة كوزموبالتينة منفتحة على بحر الروم (البحر المتوسط حاليا) وتعيش بين ثغرين، ثغر البحر، وثغر النهر، هي مدينة دمياط، التي كانت البديل الرئيسي عن مدينة الإسكندرية في تلك الفترة، حيث أُهملت الإسكندرية بعد الفتح الإسلامي، وتضاءلت أهميتها، حتى القرن التاسع عشر، عندما اهتم بها مرة أخرى محمد علي باشا الذي تولى حكم مصر عام 1805.
قبل ذلك، كانت مدن أخرى مثل دمياط تلعب دورا أساسيا في حركة التجارة والانفتاح على حوض البحر المتوسط، وليس لأن الكاتبة أصلا من مدينة دمياط، جعلها تختار مدينتها لتكون مركز الرواية، بل أن دمياط في تلك الفترة التاريخية كانت بالفعل أهم ثغور مصر على البحر المتوسط. بالتأكيد كون الكاتبة دمياطية، أسهم في زيادة الإحساس بالمكان التاريخي، نتيجة الخبرات الحياتية بالمكان الحالي، تماما مثلما كان يكتب نجيب محفوظ عن أماكن عاش فيها وخبرها وتنفس هواءها كإنسان، وهو الهواء نفسه الذي تتنفسه شخوص رواياته القاهرية: الثلاثية، زقاق المدق، اللص والكلاب، خان الخليلي .. الخ. نجوى شعبان أيضا تتنفس الهواء نفسه الذي تنفسته منذ خمسة قرون: ليل (إحدى أهم شخصيات نوة الكرم) وأختها سنانية، والفتاة المسيحية آمونيت، وغيرها من شخصيات الرواية المتعددة. ومن هنا يصبح وهم الكاتبة في خلق شخصياتها أشد رسوخا من الحقيقة، بل يصبح القارئ لهذه الرواية، مصدقا لإحداثها التي ابتدعتها الكاتبة التي بحثت كثيرا في تلك الفترة التاريخية، لتقدم لنا عملا روائيا ناضجا تدب فيه الحياة والحركة، مثلما يضج فيه الموت والسكون أيضا. هنا يصبح الوهم أشد رسوخا من الحقيقة بالفعل.
هنا أيضا تتحقق مقولة أوكتافيو باث في "متاهة الوحدة" التي استعانت بها الكاتبة في افتتاحية الفصل الرابع، والتي يقول فيها: "إن العصور القديمة لا تختفي تماما، وكل الجروح، حتى أقدمها، تظل تنضح دما". إن الدماء التي سالت في القرن السادس عشر الميلادي لم تزل تنضح حتى الآن، خاصة دماء المطراوي الذي اختلف الناس حوله، والذي مات مقتولا.
تقول الكاتبة في مقدمتها: "لما عرف الناس دخيلة المطراوي بعد موته، وقعوا صرعى ما بين حبه والاستياء منه .. تساوى في التأرجح بين الحب والاستياء الكاره: المسلمون والأقباط، مسيحيو الشام والأرمن وأوربا، وكذلك اليهود والسريان في هذه المدينة العتيقة ذات الثغرين".
لقد اختارت الكاتبة أقوال الآخرين بعناية وحرص شديدين، وبما يتوافق مع أحداث وشخوص وزمن روايتها، فجاءت بالفعل معبرة عن أجواء "نوة الكرْم". ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن مثل هذه الأقوال كانت الفلسفة، أو الأساس الفلسفي، الذي قامت عليه رواية "نوة الكرم".
هذا عن أقوال الآخرين، فماذا عن أقوال الكاتبة نفسها التي تخللت الرواية، وجاءت على لسان بعض شخصياتها، وتثير بعض القضايا الفكرية والفنية؟. تحاول الكاتبة أن تخلخل بعض القناعات التي وردت في أمثلتنا الشعبية، مثل "السكوت علامة الرضا" فتستبدلها على لسان الفتاة ليل في ردها على شيخ طائفة الكحكيين الذي أراد أن يتزوجها غصبا، بقولها: "السكون علامة القهر" (ص 52).
أيضا جاء على لسان الترجمان (ضمير الرواية، وضمير التاريخ) قوله: "أنا بجمع الورق لأنكم تدمنون عادة النسيان" (ص 82). غير أن أهم ما تنبهنا إليه الكاتبة الفكر الذي يكمن وراء أحداث الفتنة الطائفية في البلاد، لقد شهدت مصر ـ منذ سنوات ـ أحداثا بين المسلمين والمسيحيين وخاصة في منطقة الصعيد، وهو الشيء نفسه الذي تشير الكاتبة إلى وقوعه في الفترة التاريخية التي تعالجها "نوة الكرم" فتقول (في ص 111): "حدثان هامان في يوم واحد، أعلن الكشاف وقوع فتنة طائفية، وحذر مناديه من مغبة الفتنة وسوء عواقبها على الجانبين، زاعما أن القبط أعادوا بناء أجزاء من كنيسة بدلا من ترميمها، وأنهم يسعون لضم أراض مجاورة لها، وإعلاء قبة الكنيسة كي تطاول المئذنة".
هنا يفسر الترجمان هذا الحدث بقوله ـ هامسا في إذن أحد محبيه ـ: "قولوا للناس أن هذه الفتنة مبتدعة لزيادة الضرائب والغرامات على المسلمين والأقباط معا، وغض النظر عن مساوئ الحكام وأصحاب الدواوين والأهم، الحفاظ على مهابتهم". ويرد عليه هذا المحب قائلا: "بالطبع سنقول، ومثلما ترى للأسف، فالمظلومون ينفسون عن مراراتهم وحنقهم بظلم الآخرين".
وعلى لسان ليث الدين (شقيق ليل) تقول الكاتبة: "القرصنة الإسلامية ما شرعت إلا ردا على ضياع الأندلس". ( ص 165) وهو قول أراد به ليث الدين تبرير عودته للقرصنة في البحر المتوسط، والتي تاب عنها لأيام قلائل قضاها على البر، ولم يتب. وهو قول خطير، حيث دائما ما يستغل الدين الإسلامي لتبرير الأفعال الخاطئة، أو لتفسير التاريخ من وجهة نظر دينية شخصية أو تبريرية.
وفي بيت الفرنسي سان كلود شوفالييه بمرسيليا، يتحدث أحد الحاضرين باللاتينية ساخرا من إقدام الإمبراطورية العثمانية على استحداث منصب شيخ الإسلام في الأزهر، كمقابل لمنصب البابا في مستعمراتهم المسيحية. (ص 180) وهو أمر يجب البحث فيه، لنقف على حقيقة الأمر. ولعل الكاتبة بحثت الأمر، ووصلت إلى هذه النتيجة التي ضفرتها في روايتها على لسان إحدى الشخصيات غير المعروفة في الرواية، ولكنها على أية حال مقولة تدعونا إلى التفكير والتأمل في الأمر إذا صدقت. تماما مثل العبارة التي جاءت على لسان الفتاة اليهودية الراقصة بيسي التي عرفتْ من تجربتيّ زواجها أن يهود المغرب مثل يهود الأندلس، يترقبون الانعتاق بظهور المسيح المنتظر، ليقودهم من حياتهم في الشتات ويعيد إليهم الاعتبار كشعب مقدس. (ص 210). فإذا كانت هذه أماني اليهود في القرن السادس عشر الميلادي، فما الحال بالنسبة إليهم في بداية القرن الحادي والعشرين؟ ينبغي علينا المقارنة لنعرف أين هم الآن من القرن السادس عشر، وأين نحن الآن من هذا القرن؟.
أيضا من القضايا الفكرية التي تثيرها الكاتبة، هذا الحوار الذي دار بين الترجمان والفتاة المسيحية آمونيت. قال لها الترجمان: أتعرفين ما هي نكبتنا يا آمونيت؟ ـ ما هي؟ ـ أن أحدا من حكامنا لم يسألنا رأينا يوما، رغم أن قراراتهم الجادة والهزلية يقع ثقلها على أعناقنا وأكتافنا. ـ وأرواحنا. ـ نعم، ثمة نكبة أخرى ستنهي هذه الحضارة العربية، أو ستدخلها في احتضار طويل. ـ ما هي؟ ـ أن الشيوخ والقساوسة يعلموننا أن التفوق في العلوم الدنيوية هو من قبيل الزيغ والضلال، مما يجعلنا في غفلة عن الدار الآخرة. يصفون من يُعمل عقله بأنه يأتي بالبدع والضلال، وقد يكون نصيبه السيف، حتى ينقذه أحد شيوخ العقيدة والشعائر ليشهد له بحسن الإسلام، يخافون من علم الكيمياء وينعتون المشتغل به بالساحر.
وهكذا تصل نجوى شعبان، عن طريق بصيرة الترجمان، إلى سر تخلفنا وتقهقرنا منذ القرن السادس عشر وحتى الآن. لقد نسي مَنْ وصف علم الكيمياء بأنه سحر، أن علم جابر بن حيان، وهو علم الكيمياء، كان يدرس في أوربا، وأن رسائله العلمية في هذا الصدد كانت تترجم ليقف عليها علماء أوربا. ليس هذا فحسب ولكن كان هناك من العلماء العرب المسلمين، الذين تدرس أعمالهم في أوربا في ذلك الوقت: أبو بكر الرازي، وابن الهيثم، وابن النفيس، وغيرهم. ألم أقل إن "نوة الكرم" تثير الكثير من القضايا الفكرية؟
إلى جانب ذلك، احتفلت الرواية بقدر كبير من المعلوماتية، ولعل عنوان الرواية نفسها "نوة الكرم" يعطي إيحاء بتلك المعلوماتية، فإذا أردنا أن نفتش عن معنى "نوة الكرْم" ـ بتسكين الراء ـ فسنجد أنها نوة بحرية متوسطية تجتاح الساحل والسفن في عرض البحر ـ كما يشير بهاء جاهين في مقاله عن الرواية بجريدة الأهرام ـ 4 يونيو 2002 ـ والذي كان بعنوان "نوة إبداعية في منتهى الكرم".
لن أتوقف طويلا عند محور المعلوماتية في الرواية، وسأكتفي بما قاله د. فخري لبيب في مداخلته أثناء مناقشة الرواية في ورشة الزيتون بالقاهرة، قال لبيب: "الجميل في الرواية هذا الكم الهائل من المعارف سواء من الكتب السماوية أو من التراث أو من التقاليد أو من اللغة والألفاظ والمفردات الموجودة آنذاك، بحيث يشعر المرء أنها بذلت جهدا كبيرا، إنها دراسة حقيقية، وتحولت الدراسة والمجهود إلى عمل إبداعي به كمية من المعارف كثيرة جدا، وفي تقديري (والكلام مازال لفخري لبيب) أن ما أوردته من معارف ومعلومات صادقة وصحيحة وتحترم القارئ، وكل معلومة وردت في الرواية تتسم بالصدق".
وما يهمنا في مجال الفن الروائي، ليس إيراد المعلومة فحسب، ولكن كيفية توظيف هذه المعلومة، وكيفية دخولها مجال الفن، فما أكثر المعلومات الملقاة الآن على قارعة الطريق، فنحن نعيش عصر المعلوماتية. وأعتقد أن الكاتبة نجحت في تضفير المعلومة بالفن الروائي. وسأدلل على ذلك ببعض الفقرات المعلوماتية.
تقول نجوى ـ على سبيل المثال ـ عن الطوب الأسود، عندما كانت تتحدث عن إحدى شخصيات الرواية وهو الخزَّاف، "إنهم يضعون الطوب في أفران مداخل للنار، دون مخارج للهواء أو الدخان، فيتكاثف السناج على الحيطان والسقف، ويتساقط على الطوب، طبقة فوق طبقة، فيكتسب اللون الأسود".
ولعل دراسة نجوى للفن التشكيلي، وإنجازها بحثين في هذا المجال، وكتاباتها النقدية في هذا النوع من الفن، هيَّأ لها رسما جيدا لشخصية الخزَّاف، فضلا عن المعلوماتية التي قدمتها في مجال صناعة الخزف. ويذكرني الخزَّاف وافتتانه بصنعته بجان باتيست غرنوي بطل رواية "العطر" لباتريك زوسكيند، فكلاهما مفتون بصناعته، وأراد أن يبلغ بها حد الكمال، فالخزَّاف ـ الذي لم تعطه الكاتبة اسما، وإنما دلت عليه صنعته ـ بلغ هوسه بعمله أنه كان لا يخرج من محترقه أسبوعا، وكان ما يؤرقه هو الوصول إلى حد الكمال الصافي في صناعة الآنية الخزفية فيراها تعيش بعده مئات السنين. لقد بكى الخزاف مرة لأن إحدى المزهريات جاءت مقاربة حد الكمال كما في خياله، وواصل بكاءه المشحون شجنا وعذابا وفرحا بإنجازه الذي استعصى وتأبَّى عليه زمنا. هو يبدع دون أي اعتبار للمردود المالي من وراء عمله. بل إنه كان يفضل عدم بيع منتجاته، ويكسرها في معظم الأحيان إذا لم تجئ على النحو المطلوب. زوجته (سنانية أخت ليل) فقط كانت تخبئ بعض المزهريات والأواني لتبيعها للسائحين أو القوافل أو قصَّاد بيت الله الحرام، وهم يمرون في طريقهم من المغرب إلى مكة المكرمة على واحة سيوه، أو واحة آمون، بالصحراء الغربية، حيث انتقل لها الخزاف بعد زواجه من سنانية، بدلا من الذهاب إلى عاصمة الخلافة الإسلامية في إسلامبول (استانبول أو الآستانة).
أما غرنوي بطل رواية "العطر" فقد ظل يجاهد من أجل التوصل إلى صناعة عطره أو رائحته الخاصة التي يسيطر بها على البشر. وبالفعل استطاع أن يسيطر عليهم بعد أن توصل إلى صيغة عطره الخاص، والتي أدت ـ في الوقت نفسه ـ إلى قتله في نهاية الرواية، حيث افتتن به أكلة لحوم البشر، فأكلوا لحمه، وتجشأوا عظامه، وكانوا في منتهى السعادة وهم يفعلون ذلك. وعلى الرغم من أن للخزاف دوره في رواية "نوة الكرم"، فهو زوج سنانية أخت ليل، إلا أن الجزء الخاص به، يصلح لأن يكون رواية قصيرة، لها طقوسها الخاصة، ولها أبعادها النفسية التي نجحت الكاتبة في رسمها وتقديمها للقارئ من خلال الصراع بين العمل المبدع الذي ينفق فيه الخزاف كل وقته، وبين متطلبات المعيشة اليومية، بما فيها معاشرة زوجته.
ولعلنا نجد حبلا سريا أو فنيا بين الخزاف وليل، فليل كانت تقوم بالنقش على الكعك، وتفننت في ذلك، وابتكرت نقوشها الخاصة، فعلى الكعكة ثمة راقصة تتعرى جزئيا في رقصة النحلة، وعلى كعكة أخرى رجل يخاصر امرأة، وجسد أنثوي فرعوني عار، وغزالة وآيل في عناق لطيف، وملك وملكة من الفراعين في قبلة. ولا يملك شيخ طائفة الكعكيين سوى أن يصف هذه النقوش، بأنها فسق. وعلى الرغم من ذلك فقد كان الشباب يتداولون المعجنات بحس تواطؤ رجيم، وعيون بها لمعة رضا وشهوة لم يكتملا، وكان موسما طيبا للكحكيين الذين حاول صغارهم تقليد هذه المناقيش بطريقة فجة.
وعلى الرغم من افتتان الناس بنقوش ليل على الكعك، إلا أنها لم تستمر في هذا الاتجاه، بل أقلعت عنه، بعد أن حاول شيخ الكعكيين النيل منها، ومحاولاتها التملص منه، على عكس الخزاف الذي مضى في فنه الخزفي مضيفا ومبتكرا، حتى وصل صيته إلى الآفاق، فحاول أحد التجار ترتيب لقاء له مع كبار خزافي العالم الإسلامي في موسم الحج. ولكن يموت الخزاف بعد أن جرفه السيل وهو في طريقه إلى الحج.
أيضا هناك مغامرة دخول الهرم الأكبر، فهي قصة متفردة في حد ذاتها، لكنها في الوقت نفسه لا تنفصل عن مسار الرواية، وهي تكشف عن العلاقة الحميمة التي نشأت بين ليل وآمونيت، حيث أسرَّتْ ليل لصديقتها: من الآن لن نفترق أبدا يا صاحبتي. لقد انفصلت ليل عن جسدها في تلك المغامرة، إنه تحلق في الآفاق العلوية، ثم تتزوج من أنطونيو باباس أو المهتدى الجريكو، صديق أخيها غياث الدين الذي يعمل قرصانا في البحر، بعد أن وعدها بأن يتوب عن القرصنة، ومن ثم تنتقل ليل إلى مغامرة أخرى على الشاطئ الآخر، حيث تترك دمياط لتعيش في جزيرة رودس ببحر الروم، وتنجب نور الدين.
وتتردد الرواية في صفحاتها الأخيرة بين حكاية ليل المسلمة، وآمونيت المسيحية ذات اللمسة الشافية عضويا ونفسيا، وتساعد آمونيت صديقتها ليل للخروج من حالتها السوداوية الترابية التي تثقل عليها وتزهدها في الحياة، ولكن تسلم ليل الروح إلى خالقها، وتأخذ آمونيت نور الدين ليعيش في كنفها. (ملأ الصغير نور حياة آمونيت لثلاث سنوات، علمته فيها إجادة التحدث بالعربية واليونانية واللاتينية، تود أن تربى الصبي على الارتباط الشديد بها ليفعم حياتها بأنس عائلي في شيخوختها ..) ثم يلتحق الفتى بخدمة الكنيسة، ويُمنح اسم جديد هو "أوغسطين".
وهنا تنتقل الرواية إلى فضاء جديد في محاولة استعادة غياث الدين لابن أخته نور الدين، خاصة بعد موته أبيه الجريكو. ولكن نور الدين يصبح قسا ويذهب إلى غرب أفريقيا للتبشير بالديانة المسيحية. وعندما عرف أن خاله يبحث عنه، أحس باطمئنان أن جذوره تبحث عنه، ولكنه فكر كثيرا وخرج بعد ساعات من عزلته على السفينة المتجهة إلى غرب إفريقيا، وقرر مستسلما لمرارة الرضى قائلا: "أنا الآن ملك الرب، لم أعد ملكا لدمائي". وهنا تعود أنواء الكرم عتية، صاخبة، هاطلة مدرارا في أمطارها.
وهكذا تخوض الكاتبة ـ باعتبارها حفيدة سليمان الترجمان ـ في قضايا دينية واجتماعية شائكة، ولكن بنعومة شديدة ممن خلال الفن الروائي، وعلى مدى جيلين من أجيال الشعب المصري في القرن السادس عشر الميلادي. ويتبقى لنا سنانية ـ أخت ليل ـ التي حصلت على مخطوطات الترجمان وقراطيسه، فأخذتها ـ باعتبارها ثروة قومية ـ ورحلت إلى عمق السودان. وتمر السنون وتحصل حفيدة الترجمان على الوثائق والقراطيس، فتوجه الشكر للجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وللمفكر السوداني الكبير محمد إبراهيم نقد، مؤلف كتاب "علاقات الرق في المجتمع السوداني"، ليكتمل الإيهام الفني بحقيقة ما جاء في الرواية من شخصيات وأحداث.